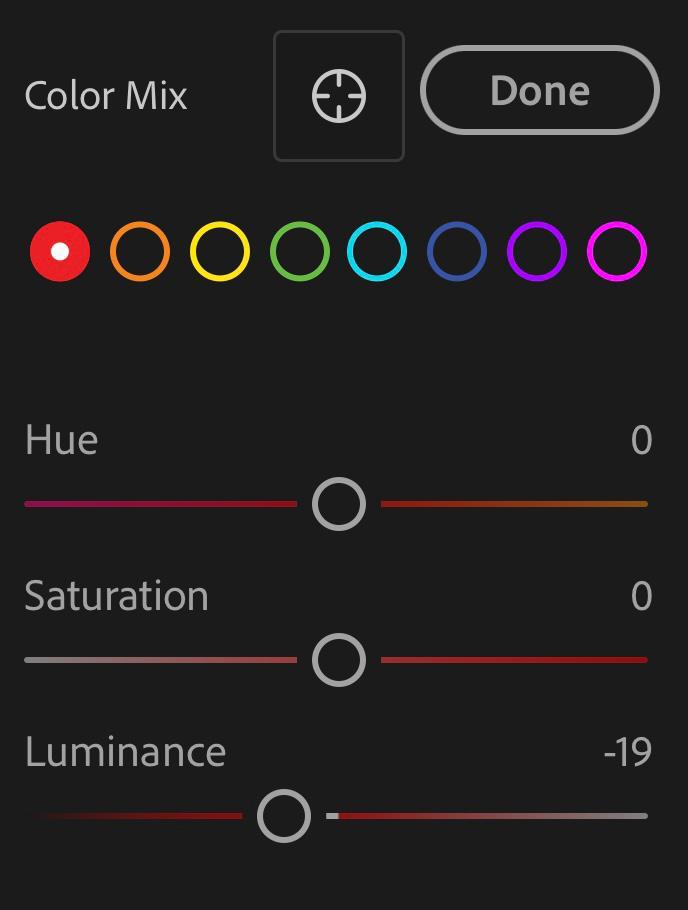شهدت إسبانيا في بدايات القرن السابع عشر واحدة من أكثر اللحظات حسمًا في تاريخها الاجتماعي والديني، وهي قرار الملك فيليب الثالث بطرد المسلمين المعروفين بـ”الموريسكيين” من البلاد عام 1609. كان هذا القرار تتويجًا لقرون من التوترات الدينية والثقافية، وهو لحظة مفصلية عكست أزمات الداخل الإسباني بعد انتهاء حروب الاسترداد وتحقيق الوحدة الكاثوليكية.
في هذا المقال، نستعرض الأسباب السياسية والدينية والاجتماعية التي دفعت الملك فيليب الثالث لاتخاذ هذا القرار، ونتعمق في سياقاته التاريخية والنتائج المترتبة عليه، لنفهم كيف ولماذا حدث هذا الطرد، وما دلالاته العميقة في تاريخ إسبانيا وأوروبا عمومًا.
السياق التاريخي: من الفتح الإسلامي إلى سقوط الأندلس
بدأ الوجود الإسلامي في إسبانيا منذ عام 711م، عندما عبرت الجيوش الإسلامية بقيادة طارق بن زياد المضيق إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وأسست حكمًا امتد لقرون عرف باسم الأندلس. وقد ازدهرت الحضارة الإسلامية هناك، وكانت مركزًا للعلم والفن والطب والفلسفة، وشكلت الأندلس نموذجًا فريدًا للتعايش الديني والثقافي بين المسلمين والمسيحيين واليهود لفترات طويلة.
غير أن هذا الوجود الإسلامي بدأ في التراجع منذ أواخر القرن الحادي عشر، مع صعود الممالك المسيحية في شمال إسبانيا. واستمرت عمليات “الاسترداد” أو “ريكونكيستا” حتى عام 1492، حين سقطت مملكة غرناطة، آخر معاقل المسلمين، على يد الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا. وعلى الرغم من اتفاقيات التسليم التي منحت المسلمين حقوقًا دينية، إلا أن هذه الحقوق لم تدم طويلًا.
-
ما هي مكونات شوربة العدس بالشعرية؟2024-05-13
التحول القسري: من مسلم إلى موريسكي
بعد سقوط غرناطة، بدأ الضغط تدريجيًا على المسلمين. في البداية، وعدتهم السلطات الإسبانية باحترام عقيدتهم وثقافتهم، لكن سرعان ما بدأت حملة تنصير قسري، أُجبر فيها آلاف المسلمين على اعتناق المسيحية. هؤلاء المسلمون الذين تم تعميدهم قسرًا عُرفوا باسم “الموريسكيين”.
ورغم تحولهم الاسمي إلى المسيحية، ظل كثير من الموريسكيين يحتفظون بعاداتهم الإسلامية، ويتحدثون العربية أو “الألخمية”، وهي اللغة العربية المكتوبة بالأحرف اللاتينية. هذا التباين بين الظاهر والباطن جعلهم محل شك دائم من قبل الكنيسة والدولة الإسبانية.
الخوف من الخيانة: الموريسكيون كـ”العدو الداخلي”
أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت فيليب الثالث إلى اتخاذ قرار الطرد هو تصاعد المخاوف من أن الموريسكيين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا داخليًا، خاصة في حال وقوع أي تحالف خارجي. كانت إسبانيا آنذاك في حالة عداء دائم مع الإمبراطورية العثمانية، العدو الإسلامي التقليدي، ومع المغرب الذي احتفظ بعلاقاته القوية مع المسلمين في الأندلس.
هذا الخوف لم يكن فقط خوفًا عسكريًا بل دينيًا وثقافيًا أيضًا. كانت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية تخشى من عودة الإسلام خفية بين صفوف الموريسكيين، وأنهم قد يُبقون على ولائهم للإسلام سرًا، بل ويربون أبناءهم على الإسلام في الخفاء، وهو ما اعتُبر خيانة دينية وسياسية في آنٍ واحد.
دور محاكم التفتيش في تغذية القرار
محاكم التفتيش كانت أداة قوية في يد الكنيسة والدولة الكاثوليكية الإسبانية لفرض العقيدة. ومنذ تأسيسها في أواخر القرن الخامس عشر، لعبت هذه المحاكم دورًا خطيرًا في مراقبة الموريسكيين. كانوا يُستجوبون باستمرار، وتُفتّش بيوتهم بحثًا عن أي مظاهر “الردة” عن المسيحية، مثل وجود المصاحف أو الامتناع عن أكل لحم الخنزير أو إقامة شعائر إسلامية سرية.
العديد من الوثائق تشير إلى أن محاكم التفتيش كانت ترفع تقارير دورية إلى الملك عن “استمرار الموريسكيين في حياتهم الإسلامية” رغم تعميدهم. هذه التقارير ساعدت في ترسيخ فكرة أن هؤلاء الناس لا يمكن دمجهم في المجتمع المسيحي، وأن الحل الوحيد هو إبعادهم تمامًا.
الدوافع الاقتصادية: أمل في التخلص من المنافسة
إلى جانب الدوافع الدينية والسياسية، لعبت العوامل الاقتصادية دورًا مهمًا في قرار الطرد. كان الموريسكيون في كثير من المناطق -وخاصة في فالنسيا وأراغون- من أكثر الفلاحين والمزارعين كفاءة، وكانوا يشكلون أساس الاقتصاد الزراعي المحلي.
لكن هذا النجاح الاقتصادي جعلهم عرضة للحسد من جيرانهم المسيحيين، الذين نظروا إليهم كمنافسين، بل وكغرباء رغم مرور أكثر من قرن على تعميدهم. لقد ساد الاعتقاد لدى بعض النبلاء والبرجوازيين الإسبان أن طرد الموريسكيين سيُتيح لهم السيطرة على الأراضي والثروات التي يملكونها.
الملك فيليب الثالث ورغبته في “التطهير الديني”
كان فيليب الثالث (الذي حكم بين 1598–1621) ملكًا تقيًا لكنه ضعيف الإرادة، وكان يُهيمن على قراراته الوزير الموثوق لديه، دوق ليرما. رغب فيليب في “تطهير” البلاد دينيًا، وتحقيق ما عجز عنه من سبقه من ملوك، وهو خلق إسبانيا كاثوليكية خالصة.
لقد اعتُبر وجود الموريسكيين –وإن كانوا مسيحيين بالاسم– نقيضًا لمشروع الوحدة الكاثوليكية. وبهذا، كان الطرد وسيلة لحل ما فشلت فيه السياسات التبشيرية والتنصير القسري، وإنهاء “المعضلة الموريسكية” بشكل جذري.
الطرد: كيف نُفذ القرار؟
في عام 1609، صدر أول مرسوم بطرد الموريسكيين من مملكة فالنسيا، تلاه مرسومان في العامين التاليين شمل باقي مناطق إسبانيا. تم تنفيذ القرار على مراحل، وغالبًا باستخدام العنف والإكراه. في كثير من الحالات، لم يُمنح الموريسكيون إلا وقتًا محدودًا لجمع ممتلكاتهم، وكان عليهم مغادرة البلاد على متن سفن نُظّمت خصيصًا لنقلهم إلى المغرب أو الجزائر أو تونس.
تُقدّر الأعداد التي تم ترحيلها بين 275 ألفًا إلى 300 ألف موريسكي. واجه العديد منهم الموت أثناء الرحلة، سواء بسبب الظروف السيئة في السفن أو بسبب الهجمات من القراصنة أو الجيوش المعادية.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للطرد
لم يكن الطرد بلا ثمن. صحيح أن الدولة ظنت أنها تخلصت من “التهديد”، لكنها فقدت شريحة كبيرة من السكان كانوا يُشكلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في بعض المناطق. انخفض الإنتاج الزراعي بشكل كبير بعد الطرد، وأُصيبت بعض المناطق بالكساد والفقر.
كما خلّف الطرد فراغًا سكانيًا وأزمة في اليد العاملة، مما أجبر الدولة لاحقًا على منح امتيازات لتشجيع مسيحيين من مناطق أخرى على الانتقال إلى الأراضي التي أُخليت من الموريسكيين.
الإرث الثقافي والسياسي لقرار الطرد
ترك قرار الطرد أثرًا نفسيًا وثقافيًا عميقًا في الوعي الإسباني والعالمي. فقد شكّل لحظة من لحظات “الانغلاق الثقافي” في أوروبا، وتُعد رمزًا للفشل في استيعاب التعدد الثقافي والديني. كما ساهم في ترسيخ فكرة “النقاء العرقي والديني”، وهي فكرة ستعود لاحقًا في أشكال أكثر تطرفًا في التاريخ الأوروبي الحديث.
أما بالنسبة للموريسكيين المطرودين، فقد شكل الطرد بداية مرحلة جديدة من التشرد، بعضهم اندمج في بلدان المغرب العربي، وآخرون استقروا في الدولة العثمانية، بينما ظل كثيرون يشعرون بالحنين إلى الأندلس المفقودة، فنشأت لدى الأجيال التالية أدبيات ومرويات تمجد الأندلس وتعبر عن ألم الفقد والمنفى.
الخاتمة: دروس من التاريخ
يُعد قرار فيليب الثالث بطرد المسلمين من إسبانيا عام 1609 من أكثر القرارات قسوة وتأثيرًا في التاريخ الإسباني. وهو يعكس لحظة اصطدام بين الدين والسياسة، بين الخوف من الآخر والرغبة في فرض هوية موحدة.
إن فهم هذا القرار لا يساعد فقط في قراءة ماضي إسبانيا، بل يقدم درسًا مهمًا للعالم المعاصر حول مخاطر التعصب الديني والسياسي، ويؤكد أن التعدد والاختلاف، مهما بدا معقدًا، هو الثروة الحقيقية لأي مجتمع>